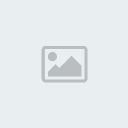السيرة النبوية > ملامح العظمة في شخصية الرسول (ص)
ملامح العظمة في شخصية الرسول (ص)
بين عظمة وعظمة:
من العظماء، من إذا استغرقت في عناصر شخصيته فإنَّك تلتقي بذاته في نطاق الدائرة المحدودة من تلك العناصر التي جعلت منه إنساناً عظيماً صاحب فكرٍ أو صاحب قوّةٍ وما إلى ذلك، ما يمنح شخصيته ضخامتها الذاتية التي لا تمتد إلى أبعد من ذلك. ومن العظماء من إذا استغرقت في داخل شخصيته فإنَّك تنفتح على العالـم كلّه، ذلك هو الفرق بين عظيم يجمّع عناصر عظمته من أجل أن يؤكّد ذاته وبين عظيم يجمّع هذه العناصر من أجل أن يعطي الحياة عظمة ويتجه بالإنسان إلى مواقع العظمة حتى تكون عظمته حركة في الحياة، حركة في الإنسان، ويجتمع الإنسان والحياة وينطلقا ليعيشا مع أجواء العظمة في اللّه العليّ العظيم.
من أولئك أنبياء اللّه الذين عاشوا للّه، فاكتشفوا الحياة من خلاله لأنَّها هبته، واكتشفوا الإنسان من خلاله، لأنَّه خلقه. وبذلك، فإنَّهم لـم يعيشوا مع اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ استغراقاً في ذاته بالمعنى العاطفي للكلمة، لتكون كلّ حياتهم مجرّد تأوّهات وتنهّدات وحسرات وما إلى ذلك، ولكنَّهم رأوا بأنَّهم عندما ينقذون الإنسان من جهله، إنَّما بذلك يعبدون اللّه، فقد ارتفعوا إلى اللّه من خلال رفعهم للإنسان إلى مستوى المسؤولية عن الحياة من خلال تعاليم اللّه، عاشوا الآلام والحسرات مع اللّه من خلال حملهم لآلام الإنسان وتنهّداته من أجل أن تنطلق روحانيتهم في قلب مسؤوليتهم.
ولذلك فالأنبياء ليسوا شخصياتٍ عظيمةً تعيش في المجال الطبقي الذي يصنعه النّاس لعظمائهم، ولكنَّ الأنبياء كانوا يعيشون مع النّاس، كانوا فيهم كأحدهم، يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، يفتحون قلوبهم لإنسان يعيش ألماً من أجل أن يفسحوا المجال للفرح حتّى يطرد ذلك الألـم، يتواضعون للنّاس، يستمعون إلى آلامهم، يشاركونهم، يعيشون معهم، لا يتحسّسون في أنفسهم أيّة حالة علوّ وهم في المراتب العليا، وممّا تنقله لنا السيرة »بأنَّ رسول اللّه كان ذات يوم يسير ورأته امرأة فارتعدت هيبةً له فقال (ص): ما عليك إنَّما أنا ابن امرأة مثلك كانت تأكل القديد«.
إنَّه لـم ينفتح على ما عاشته من هيبته لتكون هيبته فاصلاً بينها وبين إحساسها الإنساني به وإحساسه الإنساني بها، لـم يرد للعظمة أن تكون حاجزاً بين إنسان وإنسان كما يفعل الكثيرون ممن يتخيّلون أنفسهم خطباء أو يرفعهم النّاس إلى صفوف العظماء فإذا بك تجد بينهم وبين النّاس حواجز وحواجز لا يعيشون التفاعل مع النّاس، وبذلك سقطت عظمتهم من خلال ما كانوا يؤكدونه من عظمتهم.
سرّ الإنسانية في النبوّة:
أمّا رسول اللّه (ص) فقد ارتفع إلى أعلى درجات العظمة عندما عاش حياة الإنسان، محتضناً له، ليرحمه وليرأف به، فلأنَّ سرّ إنسانيته في سرّ نبوته، في سرّ حركته في الحياة. لذلك قد نجد أنَّ بعض النّاس يتحدّثون في أشعارهم عن جمال الرسول (ص) وعن لون عينيه وعن جمال وجهه ويتغزّلون به من خلال ذلك، في الوقت الذي نرى أنَّ اللّه لـم يتحدّث عن كلّ ذلك، والسبب في ذلك أنَّ اللّه أراد أن يقول لنا بأنَّ الأنبياء الذين هم رسل اللّه إلى النّاس، انطلقوا مع الإنسان في صفاته الإنسانية التي تلتقي بالإنسان الآخر، أن تكون أيّ شيء في جمالك، أن تكون أيّ شيء في خصائص جسدك ذاك شيء يخصك لا علاقة له بالنّاس، لكن ما هي أخلاقك، ما هي انفعالاتك بالنّاس، ما هو احتضانك لحياة النّاس، ما هي طبيعة أحاسيسك، هل هي أحاسيس ذاتية تعيشها في ذاتك أو هي أحاسيس إنسانية تحتضن بها أحاسيس النّاس؟ كيف قدّمه اللّه إلينا؟
لـم يذكر لنا نسبه، ونحن دائماً نصرّ على العائلية في الحديث، فلـم يتحدّث لنا عن هاشميته ولا عن قرشيته ولا عن مكيته، لـم يحدّثنا عن اسم أبيه، عن اسم أمّه، ولكن حدّثنا عنه بصفته الرسولية الرسالية: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم}، لـم يأتِ من فوق ليطلّ عليكم من علياء العظمة، ولد بينكم، عاش معكم، تألَّـم كما تتألمون، وعاش الجوع كما تعيشون، وعاش اليُتم كما تعيشون اليُتم عندمـا تكونون أيتاماً، {من أنفسكم} وكلمة من أنفسكم تحمل في داخلها عمق المعنـى الإنسانـي الذي يجعل النبيّ (ص) في الصورة القرآنية إنساناً مندمجاً بالنّاس الآخرين، يعيش معهم، من داخل حياتهم، من داخل آلامهم، من داخل أحلامهم، من داخل قضاياهم، بحيث لا يوجد بينهم وبينه أيّ فاصل، إنَّه يتابعكم وأنتم تتألمون، يتابعكم وأنتم تتعبون، يتابعكم وأنتم تواجهون مشاكل الحياة التي تثقلكم، يعزّ عليه ذلك ويؤلمه ويثقله، لأنَّه يعيش دائماً في حالة نفسية متحفزة تراقب وترصد كلّ متاعبكم ومشاقكم {حريص عليكم} وكلمة حريص هنا تختزن في داخلها الكثير من الحنان، من الأبوة، من الاحتضان، من العاطفة.. يحرص عليكم فيضمّكم إليه، فتعيشون في قلبه، يقدّم لكم حلولاً لمشاكل حياتكم، عن كلّ تعقيداتكم، يحرص عليكم فيوحّدكم، ويجمع شملكم تماماً كما يحرص الأب على أبنائه والأم على أولادها، حريصٌ عليكم يخاف أن تضيعوا، يخاف أن تسقطوا، يخاف أن تـموتوا، وهو {بالمؤمنين رؤوف رحيم} (التوبة:128) الرأفة كلّها والرحمة كلّها، والرحمة في القرآن الكريـم ليست مجرّد حالة عاطفية، نبضة قلب وخفقة إحساس، بل الرحمة هي حركة الإنسان فيما يمكن له أن يحمي الإنسان، من نفسه، ومن غيره، من أجل الانطلاق بالإنسان.
رسول الرحمة:
ألـم نقرأ الآية الثانية وهي تحدّثنا عنه {فبما رحمةٍ من اللّه لنت لهم}، هذه الرحمة الإلهية التي أنزلها اللّه على النّاس من خلال تجسّدها في النبيّ، بحيث بعث إليهم رسولاً يعيش وعي الواقع ويواجه كلّ التحجّر، تحجّر التقاليد، والعادات والعقائد، والتعقيدات، وما إلى ذلك، فيواجه ذلك وهو يرى أنَّ هذا التحجّر يمكن أن يتحوّل إلى حجارة ترميه تماماً كما كانت الحجارة تدمي رجليه وهو في الطائف، وكما كانت حجارة القذارات تثقل جسده وهو عائد من البيت الحرام أو ساجد بين يديّ ربِّه. كان يعرف أنَّ هناك تحجّراً، وأنَّ الذي يريد أن يبعث الينابيع في قلوب النّاس لا بُدَّ له أن يكتشف في الحجارة شيئاً من الينبوع، لأنَّ اللّه حدّثنا أنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الماء، إنَّ هناك ينابيع في قلب الحجارة، لذلك لا تنظر إلى حجرية الحجارة ولكن انفذ إلى أعماقها.
لذلك لا تنفذ إلى النّاس المتحجّرين لتقول إنَّ هؤلاء لا ينفع معهم كلام ولا يمكن أن ينطلقوا إلى الحوار، اصبر جيّداً، انطلق بالينبوع من قلبك، ليكن قلبك ولسانك لينين، فإنَّ لين القلب ينفذ إلى أعماق الحجارة ليخرج منها الماء، ولين الكلمة تنفذ إلى حجارة العقل من أجل أن تفتح فيها أكثر من ثغرة {فبما رحمة من اللّه لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك} (آل عمران:159)، قال ذلك لكلّ إنسان يحمل مسؤولية فكر يريد أن يُقنع به إنساناً، أو يحمل مسؤولية عاطفة يريد أن يفتح عليها قلب إنسان، قال: أيُّها الإنسان المسؤول: المسؤولية تعني وعي إنسانية الآخر والصبر عليه، إن كنت مسؤولاً لا تصبر ابتعد عن المسؤولية، لأنَّك سوف تثقل النّاس فيما تعتبره مسؤوليتك، وإن لـم تعِ أمور النّاس، ولا تفهم حركية عقولهم وقلوبهم وأوضاعهم الحياتية فكيف يمكن أن تخاطب النّاس؟ فتِّش عن مفتاح الشخصية، وهو مفتاحٌ لا تصنعه عند صانع المفاتيح ولكن تصنعه وتأخذه من خلال خالق المفاتيح {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاَّ هو} (الأنعام:59).
ومن مفاتيح الغيب تنطلق مفاتيح الرسالة، ومن مفاتيح الرسالة تنطلق مفاتيح الوعي وتنفتح الحياة كلّها، صفاته هي رسالته، ولذلك إذا أردت أن تتحدّث عن صاحب أيّ فكرة فلا بُدَّ أن تتحدّث عن أخلاقيته في حركة الفكرة، لأنَّ ذلك هو الرابط الأساسي له بالنّاس، أمّا في مجال العلاقة بالإنسان الذي يتحلَّى بالجمال ويتمتع بقوّة جسدية فذلك ينحصر في المجال الذاتي لشخصيته، أمّا عن علاقة الإنسان بالإنسان فهي علاقة حركة الفكر، الذي يحتاجه الإنسان من إنسان آخر.
الأسوة والقدوة:
وهذا ما يحدّثنا اللّه عنه في صفات رسوله (ص)، فإنَّه يقول لنا: {لقد كان لكم في رسول اللّه أسوةٌ حسنة} (الأحزاب:21)، فتقولون هذه صفات رسول اللّه فأين نحن من رسول اللّه؟ إنَّ اللّه يقول لكم: إنَّ رسول اللّه انطلق في سيرته من خلال رسالته ورسالته بين أيديكم، فإذا لـم تستطيعوا أن تقتربوا من مستوى العظمة في وعيه لرسالته، ولـم تستطيعوا أن تبلغوا القمة حاولوا أن تقتربوا من القمة ولو قليلاً، والقدوة في المسألة الإنسانية هي إيحاءٌ للإنسان إن بإمكانك أن تقترب من القمة إذا لـم تستطع أن تصل إليها. وهكذا لن يكون الرسول (ص) مجرّد رسول في التاريخ، ولكنَّه ـ وذلك سرُّ عظمته ـ كان رسالة في رسوليته، وكانت رسوليته هي الامتداد لشخصيته، حتّى أنَّنا نشعر أنَّ حضوره فينا ونحن نصلّي عليه ونستحضر سيرته وندرس سنته ونقرأ القرآن الذي بلَّغه، بأنَّ حضوره فينا كأفضل الحضور أعظم من حضور كثيرٍ من النّاس الذين يحسبون أنفسهم حاضرين ولكنَّهم غائبون عن الأمّة، قد يكونون حاضرين في الساحة بأجسادهم ولكنَّهم غائبون عن عقول الأمّة وقلوبها وإحساسها، وقضية الحضور والغياب هي في مدى وعي النّاس الذين تعيش في داخلهم لا من خلال الحجم الذي تتّخذه لنفسك في سلطانك.
لذلك مَنْ مِنَّا ـ وكلّ واحد منّا يحمل مسؤولية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسؤوليته العائلية، التربوية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، أيّ شيء فيما يتعامل معه النّاس من مسؤوليات ـ مَنْ مِنَّا يعيش هذه الروح في الكلمة اللينة، القلب اللين، الروح التي يشق عليها تعب الذين يعيشون في داخل مسؤوليتك، الحرص الذي يشعر به على حياة النّاس الذين يتحرّكون من خلال مسؤوليتك؟!
لن نكون في خطّ رسول اللّه إذا لـم يتحوَّل كلّ واحد منَّا إلى رسول اللّه ولو بنسبة العشرة بالمائة، أو من خلال القدوة، وعلى الإنسان في حال اعترضته مشاكل نفسية وبيئية وما إلى ذلك أن يخترق كلّ الحواجز، والمهم في كلّ ذلك أن نمتلك الإرادة.
قصتنا في كثيرٍ من الحالات، هي هذا الفاصل بين الفكرة والإرادة، بين الرغبة والحركة، الرغبات تبقى أحلاماً، وبدلاً من أن نُنـزل هذه الأحلام إلى الواقع نحاول أن ننطلق بها إلى الخيال، والفكرة تبقى في عقولنا مجرّد معلومات، والقيمة الكامنة في المعلومات هي عندما تتحوّل إلى واقع، وإلاَّ كانت وهماً، كثيرٌ من الفلاسفة حشروا أنفسهم وتحوّلت فلسفاتهم إلى هواء، وأصبحت مجرّد شيء يُتعب عقلك ولا يغذي الحياة.. وجاء النّاس الذين يفكرون في الإنسان في رسالتهم، واستطاعوا أن ينطلقوا بالإنسان إلى مجالات واسعة.
إذاً قيمة الفكرة أن تتحوّل إلى واقع، ونحن نعرف، حتّى في قرآننا وفي سنتنا، أنَّه لا قيمة للإيمان إذا لـم يكن مقترناً بالعمل الصالح، لأنَّ العمل الصالح هو حركية الإيمان في واقعك، كما أنَّ الإيمان هو حركية الصلاح في عقلك، وعندما تكون صالحاً في عقلك من خلال إيمانك وتكون صالحاً في عملك من خلال حركة إيمانك، عند ذلك يمكن أن تعطي الحياة صلاحاً، هذا هو {وإنَّك لعلى خلق عظيم} (القلم:4)، هل الخلق ابتسامة؟ هل الخلق مجرّد مصافحة حنونة؟ هل هو مجرّد مجاملات؟ هل الخلق حالة عناق أو احتضان؟ الخلق هو أنت في كلّ حركتك في الحياة، الأخلاق تختصر كلّ حياتك، علاقتك بنفسك هي خُلُق، علاقتك باللّه، علاقتك بعيالك، علاقتك بالنّاس الذين تعمل معهم ويعملون معك، علاقتك بالحكم، بالحاكم، بالقضايا الكبرى. وبعبارة أخرى، الأخلاق ليست شيئاً على هامش حياتنا، إنَّما هي كلّ حياتنا، هي أسلوبنا في الحياة، أسلوبنا في التعامل، أسلوبنا في الكلام، أسلوبنا في اتخاذ المواقف، أسلوبنا في تحديد المواقع، أسلوبنا في مواجهة التحدّيات، ولذلك رأينا أنَّ رسول اللّه (ص) اختصر الإسلام كلّه بكلمة واحدة: «إنَّما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق».
الرسالات كلُّها هي حركةٌ في واقع الإنسان من أجل أن تتمِّم له أخلاقه، ولكلّ مرحلة أخلاقها، وتأتي المرحلة الثانية لتكمل ما نقص ممّا جدّ واستجدَّ من قضايا الحياة ومشاكلها، حتى كان ختام الأخلاق الرسالية هو ختام الرسالة في محمَّد (ص) الذي جاء ليتمِّم ويكمل للإنسان أخلاقه، وانطلق بالإسلام لا ليكون ديناً في مقابل الأديان، ولكنَّه دين يحتضن كلّ الأديان، مصدّقاً لما بين يديه، يؤمن بالرسل كلّهم، ينطلق ليأخذ من كلّ رسالة ما أراد اللّه له أن يأخذه ممّا يبقى للحياة، لأنَّ هناك شيئاً في الرسالات قد يكون مرحلياً، ولذلك جاء عيسى (ع) ليحلّ لهم بعض ما حرّم عليهم، وجاء موسى قبله ليحرّم عليهم بعض ما أحلّ لهم. والقضية هي أنَّ قيمة الإسلام هي هذه، الإسلام ليس ديناً في مواجهة اليهودية، كما يواجه الفكر الخصم فكراً خصماً آخر، وليس في مواجهة النصرانية، ولكنَّه يحتضن ما يبقى من النصرانية وما يبقى من اليهودية وما يبقى من صحف إبراهيم وما يبقى من كلّ النبوَّات صغيراً أو كبيراً، ليقول للإنسان كلّه: أيُّها الإنسان، لقد كان هناك تاريخ للرسالات وأنا اختصرت لك كلّ هذا التاريخ، آمن بالرسل كلّهم، ولتكن حياتك في خطّ الرسل كلّهم، فأنا خاتمهم وأنا معهم أسير.
خصوصية الإسلام:
ولذلك فإنَّ مقدسات اليهودية في رموزها هي مقدّساتنا، وكذلك فيما يتعلّق برموز النصرانية ومقدّساتها، قد ينطلق يهودي أو نصراني ليسبّ مقدّساتنا، ولكنَّنا لا نستطيع أن نقف بردة فعل لنسبّ مقدّسات هذا أو ذاك، لأنَّ مقدّساتهم مقدّساتنا، لأنَّ موسى كما عيسى هما من أنبيائنا، ولأنَّ مريـم العذراء (ع) هي الإنسانة التي كرّمها اللّه وطهَّرها وفضَّلها على نساء العالمين، لذلك ماذا نقول؟ إنَّنا ندعو لهم بالهداية، هذا ردّ فعلنا، وهكذا نتعلّم من هذه الشمولية في حركة الإسلام الذي يمثّل إسلام القلب والعقل والفكر والوجه للّه ـ سبحانه وتعالى ـ ننطلق لنكون المنفتحين على الحياة كلّها وذلك من خلال الرسول إلى الرسالة.
فنحن نقرأ القرآن، والقرآن يحدّثنا عن كلّ ما أثير حول الرسول (ص) من خلال ما قال عنه المشركون بأنَّه ساحر، شاعر، كاهن، كذاب، كما قالوا عن القرآن بأنَّه {أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً} (الفرقان:5)، وقالوا عنه {إنَّما يعلّمه بشر}.
لقد حدّثنا القرآن عن كلّ ذلك، وبلّغ الرسول (ص) هذه الاتهامات للنّاس، قائلاً للذين لـم يعيشوا تجربة مكة، ومن خلال آيات اللّه: هذا نبيّكم قيل عنه إنَّه مجنون وقيل عنه إنَّه كاذب وساحر وكاهن وقيل عن قرآنكم إنَّ هناك بشراً علم النبي!! لـم يخف من أن يضل النّاس بالحديث عن نقاط الضعف التي أثاروها زوراً وبهتاناً.
ونستوحي من خلال ذلك بأنَّ الإنسان الذي يملك الحقّ لا يخاف من كلّ الكلمات التي تصوّر حقّه باطلاً. إذا كنت إنساناً تملك قوّة الحقّ في حياتك فليقل النّاس ما يقولون، عليك أن لا تخاف، لأنَّ الحقّ أقوى من كلّ ما يقولون إذا كانوا يقولون الباطل، واللّه تكفّل أن يزهق الباطل، أن يزهقه من عقول النّاس إذا لـم يُزهق من حياتهم.
كما أنَّنا نتعلّم من ذلك أن لا نتعقّد عندما نكون مسؤولين، أن لا نتعقّد من الاتهامات التي توجّه إلينا.. كن مسؤولاً في موقع ديني، كن مسؤولاً في موقع اجتماعي، كن مسؤولاً في موقع رسالي، إنَّ معنى مسؤوليتك هي أنَّك تقف موقف التحدّي لفكر الآخرين ولمصالح الآخرين أو لأوضاع الآخرين، ولذلك من الطبيعي أن يحاربك الآخرون منذ البداية بما يكذبون ويفترون، عليك أن تعتبر أنَّ ذلك أمر طبيعي في ساحة الصراع.
.. في مواجهة الشتائم:
ومن يخاف أن يشتمه النّاس أو أن يتهموه أو أن يرجموه عليه أن ينسحب من المسؤولية، لأنَّ المسؤولية تحتاج إلى إنسانٍ يملك صلابة العقل الذي لا تهزه التحدّيات الفكرية، وصلابة القلب الذي لا تُسقطه التحدّيات الانفعالية، وصلابة الموقف الذي لا تهزّه التحدّيات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. عندما تريد أن تكون مسؤولاً حاول أن تصلّب عضلاتك، لا عضلات يديك، بل عضلات عقلك، لأنَّ للعقل عضلات، حاول أن تصلّب عضلات قلبك، عضلات حركتك، عند ذلك تكون كما قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) لولده محمَّد وهو يقف في المعركة: »تدْ في الأرض قدمك، أعرِ اللّه جمجمتك، ارم ببصرك أقصى القوم، تزول الجبال ولا تزول«.
وكانت هناك جبال من الشتائم والاتهامات لرسول اللّه وزالت كلّ تلك الجبال، وبقي رسول اللّه وبقيت رسالته، قالوا عنه إنَّه مجنون، تعلّموا أساليبه عندما تواجهكم الأساليب الظالمة غير الواعية، {قل إنَّما أعظكم بواحدة}، استدركوا لحظةً في أنفسكم عندما يتهمكم أحد بالجنون، كيف وأنت شخصٌ محترم في عائلتك، في موقعك الاقتصادي، في موقعك السياسي، ويأتي من يتّهم عقلك، أو أن يكذبوه، ونسوق مثالاً على ذلك ما كان يتعرّض له رسول اللّه (ص) من أقربائه، كأبي لهب الذي كان يتتبّعه ويقول: «لا تصدّقوا ابن أخي، فإنَّه مجنون ومن أعرف بالإنسان من عمّه«، كيف تكون أعصابك، كيف تكون ردود فعلك؟ ألا تنطلق لتستبدل شتيمة وكلمة جارحة بكلمة جارحة؟! وكلّنا نعتبر أنَّ لنا العذر {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (البقرة:194)، ولكنَّ رسول اللّه لـم يكن شخصاً يستغرق في ذاته، بعد أن قال اللّه له لا تنفعل ولا تحزن، القضية ليست قضيتك، {فإنَّهم لا يكذبونك ولكنَّ الظالمين بآيات اللّه يجحدون} (الأنعام:33)، ولذلك يقول له: {واصبر على ما أصابك إنَّ ذلك من عزم الأمور} (لقمان:17) فالقضية هي قضية رسالة لا بُدَّ أن تحطِّم الحواجز، وتحطيم الحواجز الإنسانية أخطر من تحطيم الحواجز الحديدية وما إلى ذلك.
{قل إنَّما أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه مثنى وفرادى ثُمَّ تتفكروا ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلاَّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد} (سبأ:46)، إنَّه أراد أن يعلّمهم المنهج في وعي القضايا التي يخطئون فيها، لقد انطلق هذا الأسلوب القرآني ليتعامل معهم كما يتعامل مع إنسان مخطئ يريد له أن يكتشف خطأه، لا أن يقنعه بخطئه، أن يقول له إنّي أدلك على المنهج الذي إذا أخذت به، فإنَّك تستطيع أن تكتشف خطأك بنفسك، ما هو المنهج؟ إنَّ المشكلة ـ هكذا أراد اللّه لرسوله أن يقول لهم ـ هي أنَّكم مجتمعون لا يملك أحدٌ منكم عقله بشكل مستقل، لأنَّ الإنسان عندما يكون مع النّاس فإنَّ عقله يكون عقل النّاس.. راقبوا ذلك في أوضاعكم، قد تجلسون في محفل والنّاس يصفقون، فإنَّكم ترون أنفسكم مشدودين إلى أن تصفقوا دون أن تعرفوا لماذا يصفقون، وهكذا عندما تنطلق مظاهرات يهتف إنسان بسقوط إنسان وبحياة إنسان، إنَّك ترى نفسك تهتف دون أن تعرف لماذا وما هي المناسبة. هذا ما عبّر عنه بعض علماء النفس »بالعقل الجمعي«. وبعبارة أخرى، يفقد الإنسان في هذه الحالة عقله الذاتي، وبالتالي صفاء التفكير وصفاء المنطق.
لذلك، فإنَّ النبيّ (ص) كأنَّه كان يقول لهم من خلال هذه الآية: أنا لا أقول لكم إنّي مجنون أو لست مجنوناً، لا أدافع عن نفسي بشكل مباشر، لكن أنصحكم وأطلب منكم شيئاً واحداً أن تقوموا للّه، واجهوا القضية من موقع إرادة وعي الحقيقة لا من موقع العصبية؛ مثنى، اثنين اثنين تتحدّثان فيما بينكما؛ فرادى، واحداً واحداً يفكّر، فكِّروا مثنى وفرادى، فكِّروا في كلماتي، فكِّروا في طريقتي في الحياة، فكِّروا في كلّ أوضاعي، فإنَّكم إذا فكَّرتـم بهدوء فستعرفون أنَّ صاحبكم ليس مجنوناً، ولكنَّه يحدّثكم عن شيءٍ على جانب كبير من الأهمية يخصُّ مصيركم {إن هو إلاَّ نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديد} (سبأ:46).
وهذا المنهج هو المنهج الذي يضعه الإسلام أمام الإنسان ليقول له: عندما تريد أن تركّز فكرةً لتعيش صفاءها ونقاءها وعمقها اجلس مع نفسك وفكِّر، اجلس مع إنسان آخر وفكِّر معه، وإيّاك أن تتبنى أفكاراً أو تضع أفكارك وأنت بين النّاس، لأنَّ النّاس سيفرضون عليك بهذا التيار الضاغط فكراً لـم تختره، وفكراً لو حرّكته بهدوء لما اقتنعت به، تماماً كما هو التيار عندما تقف في مواجهته، فإنَّك لا بُدَّ أن تسير معه، أمّا عندما يكون البحر هادئاً فإنَّك تستطيع أن تسبح بإرادتك وتعرف كيف تحرّك يديك بطريقتك الخاصة.
وهكذا كان أسلوبه يتنوّع من خلال أنَّه يريد للنّاس أن يقتنعوا على أساس وعيهم للقضية، ولذلك كان لا يستعجل اللّه العذاب، بل كان يقول: »اللهم اغفر لقومي فإنَّهم لا يعلمون«. هل نطيق مثل ذلك؟ هل يطيق المسؤولون مثل ذلك؟ أياً كان المسؤولون؟! إنَّ المسلمين لا بُدَّ أن يكونوا كذلك، لأنَّ هذه ليست صفة من خصائص الرسالة في شخصية الرسول، ولكنَّها صفةٌ من خصائص الرسول في معنى الرسالة، ويمكن للنّاس أن يأخذوا بها. كان الرسول يخاطب الآخرين ولو لـم يكونوا قادرين على ذلك لما خاطبهم بذلك.
لنتعلّم من سيرته (ص):
إنَّنا عندما ننفتح على الرسول فعلينا أن ننفتح على كلّ سيرته، لأنَّ سيرته كانت رسالةً كما جاء في تعريف سنّة النبيّ (ص): »السنّة قول النبيّ أو فعله أو تقريره«، قوله سنّة، وحركته في الحياة سنّة، ورضاه بما يرى ممّا يقرّ النّاس عليه سنّة، لذلك هو شريعة بكامله، وقد عبّرت إحدى زوجاته بإيجاز عن خلقه فقالت: »كان خلقه القرآن«. فإذا أردتـم أن تدرسوا سيرته (ص)، فليس من الضروري أن تقرأوا سيرته في كتب السيرة، بل اقرأوا القرآن بكلّ أخلاقياته، وبكلّ حرامه وحلاله، وبكلّ حركته في الحرب والسلم، فستجدون أمامكم الصورة الواضحة لمحمَّد (ص)، لأنَّه عاش القرآن في كلّ كيانه قبل أن يبلّغه للنّاس، فكان القرآن الناطق، وكان ما يسمعونه القرآن الصامت.
في حركته يتجسّد القرآن، وهذا هو الالتزام الإسلامي، وعليه يجب أن نركّز، لأنَّ ذكرى المولد أو أيّ ذكرى في مناسباته ليست احتفالاً نعيش فيه فرح أدبياته، ولكن أن نعيش فرح حياتنا ومصيرنا، ذلك هو الفرح الحقيقي.. لا بُدَّ أن نكون قرآنيين إذا أردنا أن ننطلق في النور، وعندما تكون قرآنياً عليك من خلال التزامك بالقرآن أن يكون انتماؤك للقرآن لا لشيء غير ذلك، فكما لا يمكن أن يكون للّه شريكٌ في عقيدتك كذلك لا يمكن أن يكون للإسلام شريكٌ في انتمائك، أن تكون مسلماً يملأ الإسلام كلّ فراغ عقلك وكلّ فراغ قلبك وكلّ فراغ أحاسيسك وكلّ فراغ شهواتك وغرائزك وحركتك وعلاقاتك ومواقفك من خلال ذلك {اليوم أكملت لكم دينكم} فلا تبحثوا عن شيء آخر، لأنَّ الذي يبحث عن شيء آخر إنَّما يبحث عمّا نقص لديه من دنياه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} (المائدة:3)، فإذا كان اللّه رضي لنا الإسلام ديناً أفلا نرضى بما رضيه اللّه لنا؟!
والإسلام ليس هامشاً من هوامش الحياة أو من هوامش التشريع، هو كلّ الحياة لو فهمناه، هو كلّ الواقع لو وعيناه، هو كلّ الشريعة لو أخذنا بدقائقه وبكلّ مفرداته وقواعده.
لذلك لا تعيشوا الازدواجية، كلّنا نعرف الحقيقة الإنسانية، الإنسان لا يعيش حياته مرتين، إنَّ بعض النّاس عاشوا حياتهم بعيداً عن اللّه لأنَّهم كانوا في غفلة عنه، وعندما حان وقت لقاء اللّه ورأوا الحقيقة {قال ربّي ارجعون * لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت} (المؤمنون:99ـ100)، أعطني يا ربّي حياةً ثانية أعيش فيها الحقّ بعدما سرت في حياتي الأولى وعشتها!، ليست هناك حياة ثانية، كما أنَّ الحياة الواحدة لا تنقسم.
كيف تقسّم عقلك لتكون مؤمناً في جانب وملحداً في جانب آخر؟ كيف تقسّم قلبك لتحبّ اللّه في جانب من قلبك ولتحبّ الشيطان في جانب من قلبك؟ اللّه لا شريك له في العقيدة ولا شريك له في الحبّ، حتى عندما تحبّ النّاس الآخرين لا بُدَّ أن تحبّهم من طريق اللّه، »إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر قلبك، فإن كان قلبك يوالي أولياء اللّه ويعادي أعداء اللّه ففيك خير واللّه يحبّك، وإن كان قلبك يوالي أعداء اللّه ويعادي أولياء اللّه فليس فيك خير واللّه يبغضك، والمرء مع من أحبّ« فاعرف من تحبّ لتعرف أين تسير، لأنَّ اللّه يحشرك مع من تحبّ.
ولذلك عندما ينحرف قلبك وتنحرف عواطفك حاول أن تمسك قلبك لتفكر: لو قال اللّه يا فلان إنّي أحشرك مع من أيّدته اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو عاطفياً فهل تقبل؟ إذا كنت تقبل ذلك من موقع الإيمان فأيِّده، وإذا لـم تقبل ذلك فوفّر على نفسك أن تحشر مع الذين يساقون إلى النّار، القضية بسيطة جداً ليس فيها فلسفة وليس فيها تعقيدات، القضية واضحة، الطريق المستقيم هو أقرب بُعدٍ بين نقطتين {وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله} (الأنعام:53).
إذاً أن نكون مسلمين، هو أن لا نتعصّب ضدّ غير المسلمين، وأن نقول لهم: {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلاَّ اللّه ولا نشرك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه} (آل عمران:64)، لن نتعقّد حتّى من الذين لا يؤمنون بدين ونقول لهم: {هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} (البقرة:111)، {ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فَلِمَ تحاجُّون فيما ليس لكم به علم} (آل عمران:66)، لن نتعقّد من أحد، ولكنَّنا نحبُّ النّاس كلّهم، نحبّ الذين نتفق معهم من أجل أن نلتقي بهم ونتعاون معهم، ونحبّ الذين نختلف معهم لنهديهم إلى سواء السبيل. الحاقد لا يستطيع أن يهدي أحداً، الأنبياء كانوا يبكون على النّاس. اللّه كان يخاطب النبيّ بين وقت وآخر {فلا تذهب نفسك عليهم حسرات} (فاطر:8)، كان النبيّ عندما يواجه الكافرين يتحسر عليهم الحسرة تلو الحسرة، لأنَّه كان يحبّ النّاس كلّهم ومن خلال حبّه لهم كان يهديهم إلى سواء السبيل.
لذلك نحن لسنا المسلمين الذين نعيش العقلية التدميرية ضدَّ أيّ إنسان، ولن نعيش العاطفة السلبية ضدّ النّاس، لقد علّمنا اللّه أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، أن نجادل كلّ النّاس بالتي هي أحسن، وأن ندعو إلى سبيل ربّنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نقول التي هي أحسن، وأن نوازن بين الحسنة وبين السيئة، وندفع بالتي هي أحسن، حتّى نحوِّل أعداءنا إلى أصدقاء.
إذاً نحن لا نسيء إلى سلام العالـم من خلال اختلاف فكرنا عن بعض إنسان هذا العالـم، ولكنَّنا نؤكّد سلام الإنسان من خلال سلام الفكرة التي ترتكز على أسس علمية. أن تكون مسلماً ليس معنى ذلك أن تكون عاطفياً في المسألة، أن تكون مسلماً أن تأخذ بأسباب العلم، اللّه أراد للمسلمين أن يزدادوا علماً حتى أطلقه دعاءً يختصر كلّ العلم {وقل ربّي زدني علماً} (طه:114)، وأكّد سبحانه في القرآن على العلم وهو يميّز بين النّاس {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}، وعلى الذين يملكون العقل {إنَّما يتذكر أولو الألباب} (الزمر:9)، كما أكَّد على الإنسان في أيّ موقع من مواقع حياته أن لا يتَّبع ما ليس له به علم، في كلّ شيءٍ يأخذ به، في كلّ شيءٍ يلتزمه، في كلّ شيءٍ ينتمي إليه، في كلّ شيءٍ يتحرّك معه، {ولا تقفُ ما ليس لك به علم إنَّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً} (الإسراء:36). لا بُدَّ أن يكون لك وضوح الرؤية، ووضوح الكلمة المسموعة، ووضوح الفكرة المعقولة، سيسألك اللّه عن البصر وما رأى، وعن الأذن وما سمعت، وعن العقل وما وعى.
أمّ الحضارات:
لذلك أن تكون مسلماً يعني أن تتحرّك في حياتك من موقع علم ينظّم لك الحياة، ومن موقع عقل يؤكّد لك الفكرة. وبذلك فإنَّ المجتمع الجاهل ليس هو المجتمع الذي يحبّه الإسلام لأتباعه، والمجتمع المتخلّف ليس هو المجتمع الذي انطلق الرسول (ص) لصنعه، ومن هنا علينا أن نعرف أنَّ هذا التخلّف والجهل في الواقع الإسلامي هو شيءٌ غير إسلامي. إنَّ الإسلام استطاع أن يصنع الحضارة التي غذّت ما بعدها من الحضارات، ففي مدى أقلّ من مائة سنة، أصبحت الحضارة الإسلامية في عقلانيتها وفي علومها وفي أفكارها ومفاهيمها وأساليبها الفكرية تغذِّي الحضارات الأخرى. ونحن نقرأ في كتابات بعض المفكرين الغربيين: »إنَّ الحضارة الإسلامية هي أمّ الحضارات الحديثة«، لأنَّ أسلوب التجربة وأسلوب الاستقراء أخذه الغربيون من علماء المسلمين عندما كانوا في الأندلس. لذلك لا بُدَّ لنا عندما نريد أن ننطلق في الأجواء الإسلامية أن ننطلق في أجواء علمية، نأخذ الأسباب العلمية من أيّ مكان، حتّى نستطيع أن نحرّك الإنسان من خلال علمٍ ينتفع به في الحياة، ومن خلال رسالة تنظِّم له أخلاقية الحياة وسلوكية الحياة وتعرّفه طرق استخدام هذا العلم في سبيل بناء الإنسان لا في سبيل تدميره.
واللّه أراد لنا أن نكون الأعزّاء، لأنَّ اللّه أرادنا أن نتخلّق بأخلاقه، فالحديث الشريف يقول: »تخلّقوا بأخلاق اللّه« واللّه العزيز يريدنا أن نكون الأعزاء {وللّه العزّة ولرسوله وللمؤمنين} (المنافقون:8)، ولكن بشرط أن لا نبتغي العزّة عند الذين لا يؤمنـون باللّه {بشّر المنافقين بأنَّ لهم عذاباً أليماً * الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزّة فإنَّ العزّة للّه جميعاً} (النساء:139).
هذا عنوانٌ يحدّد لنا كلّ علاقاتنا بالنّاس وكلّ حركتنا في كلّ مواقع الصراع، إذا أردت أن تبرمج علاقاتك مع أيِّ قريب آخر أو أن تخطِّط لحياتك ولأوضاعك في أيّ طريق، فكِّر هل هو طريق عزّة أو طريق ذلّة، هل هو طريق حرية أو عبودية، لا تكن العبد حتّى لو استعبدت جسمك للنّاس، كن الحر الرافض حتّى لو كان العالـم كلّه يرفع يده للقوي، إذا لـم تقتنع بما يقوله النّاس. المسؤولية فردية في الإسلام {يوم تأتي كلّ نفسٍ تجادل عن نفسها} (النحل:111)، {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (الأنعام:164)، {وأن ليس للإنسان إلاَّ ما سعى * وإنَّ سعيه سوف يرى} (النجم:39ـ40)، المسؤولية فردية {يا أيُّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم} (المائدة:105)، تحمَّل مسؤولية نفسك إذا لـم تستطع أن تتحمَّل مسؤوليات النّاس من حولك.
لذلك عندما تفكِّرون في القضايا المصيرية فيما يتصل بأرضكم أو فيما يتصل بحريتكم أو ما يتصل بمواقعكم في ساحات الكون بين الأمم، ابحثوا عن موقع يضمن لكم حريتكم، ابحثوا عن ساحةٍ تؤكّد عزتكم، ابحثوا عن عالـمٍ يحمي أصالتكم، القضية ليست قضية موازين القوى، قد يكون لموازين القوى دورٌ فيما هي حركة جسدك، ولكن ليس لموازين القوى دورٌ في حركة قرارك وعقلك وإرادتك، «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فمن لـم يستطع فبلسانه فمن لـم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». المهم أن لا نُغلب على عقولنا، أن نرى الحقّ باطلاً أو الباطل حقّاً، أو نرى الذلّ عزّاً أو العزّ ذلاً، كما قال ذلك الشاعر عندما يتحدّث عن أسلوب بعض النّاس: »تأنّق الذلّ حتى صار غفراناً« يحاول أن يغيّر كلمة الاستسلام بالسّلام، والذلّ بالغفران وما إلى ذلك من الكلمات.
أمامنا تحدٍٍّ كبير:
لذلك نحن كمسلمين وكعرب ـ باعتبار أنَّ أكثرية العرب هم مسلمون، وحتّى غير المسلمين من العرب إذا لـم يكونوا مسلمين دينياً فهم مسلمون حضارياً، لأنَّهم اختزنوا مفاهيم الإسلام في كلّ نموّهم الحضاري والاجتماعي ـ أمام تحدٍٍّ كبير بدأ يواجهنا منذ انطلقت الرسالة في المدينة وما زال يواجهنا حتّى الآن، والقضية أنَّ هناك واقعاً يُراد من خلاله أن يُقال للمسلمين إنَّ بني النضير وقريظة وخيبر أصبحت من التاريخ، لقد أخذنا منكم أكثر من خيبر وثأرنا لأكثر من بني قريظة أو بني النضير، إذا كانوا لا يقولون ذلك بألسنتهم فإنَّهم يقولونه من خلال مواقفهم، في الحفلة الجنائزية التي حملت فيها جنازة فلسطين في البيت الأبيض، حيث كان رئيس وزراء العدو يقف ليتحدّث عن آلام اليهود في التاريخ منذ ألفي سنة، وعن يهود المنفى ومآسيهم. هذا في الوقت الذي نجد فيه أنَّ الشخص الذي جاء يزحف إليه ويمدّ يده مدّة ليصافحه، لـم يتحدّث عن عرب ولا عن مسلمين ولا عن شهداء ولا عن مستقبل لكلّ هؤلاء المشرّدين عن أرضهم، إنَّ القضية هي: قالوا إنَّ فلسطين هي جوهر الصراع، وقد سقط الصراع بالتوقيع على ورقة الطابو، وكانوا يريدون في ورقة الطابو أن تكون فلسطين إسرائيلية. وفلسطين الآن حتى بعد اتفاق »غزة ـ أريحا« إسرائيلية، فهذا وزير خارجية العدو يقول: »إنَّنا لـم نتنازل عن الأرض وإنَّما تنازلنا عن تجمّع..« إنَّ هذا تحدٍّ كبير قد تتابعونه بطريقة استهلاكية فيما تقرأونه وتسمعونه، فتجدون مقولة النظام العالمي الجديد، واختلال موازين القوى لصالح الاستكبار، ولكن علينا أن نستمع بهدوء عقلاني قول اللّه: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * إن يمسسكم قرحٌ فقد مسّ القوم قرحٌ مثله وتلك الأيام نداولها بين النّاس} (آل عمران:139ـ140).
لماذا تصرّون على أن توقفوا الدولاب في الأسفل وهناك إمكانية أن يتحرّك الدولاب من الأسفل إلى الأعلى، لماذا تحبّون دائماً الموقع الأدنى، قال لكم اللّه: {أنتم الأعلون} ولكن {إن كنتم مؤمنين}، {الذين قال لهم النّاس إنَّ النّاس قد جمعوا لكم}، نفس الكلمة والنظام العالمي الجديد {فاخشوهم} قدّموا كلّ طاعتكم للاستكبار العالمي، عندما قالوا لهم إنَّ النّاس قد جمعوا لكم فانطلقوا إلى اللّه وأدركوا أنَّ القوّة للّه جميعاً «قل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء»، {فزادهم إيماناً} ولذلك ازدادوا بالتحدّي المضادّ إيماناً {وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل} {إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنَّ اللّه معنا فأنزل اللّه سكينته عليه وأيّده بجنودٍ لـم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اللّه هي العليا} (التوبة:40)، {... وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمةٍ من اللّه وفضلٍ لـم يمسسهم سوء واتّبعوا رضوان اللّه واللّه ذو فضل عظيم} (آل عمران:173ـ174) ().
أيُّها المخوّفون المنخذلون، أتعرفون أين هو مستوى تخويفكم {إنَّما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين} (آل عمران:175) خفِ اللّه وقِفْ أمام العالـم وكن مع اللّه، قد تقولون هذا كلام حماس استهلكناه، وهذا كلام انفعال استنفدناه. إنَّ التتر اجتاحوا البلاد الإسلامية في أكثرها ولـم يبقَ للمسلمين قوّة، ولكنَّ العقل الإسلامي اخترق عقل التتر فحوّلهم إلى مسلمين، وبذلك تحوّلت قوّة التتر إلى قوّة إسلامية بعد أن كانت قوّة دمّرت الإسلام... لماذا لا نثق بعقولنا، لماذا لا نثق بإسلامنا؟ لنتحرّك عقلانياً وعلمياً ومادياً وروحياً وننطلق.. وإذا ضاق الحاضر في مواقع قوّته، فالمستقبل قد يفتح لك أكثر من أفق. أتريدون الشواهد من عصرنا، كيف كانت بريطانيا في الخمسينات والأربعينات؟ كانت سيِّدة البحار، كيف كانت أمريكا عندما كانت مستعمرة بريطانية؟ أين أمريكا وأين بريطانيا الآن؟ كيف كان اليهود قبل الأربعينات وكيف هم الآن؟ {وتلك الأيام نداولها بين النّاس} (آل عمران:140)، إذا لـم تمتلك القوّة الآن حاول أن تؤمن بقدرتك على صنع القوّة، فقد تجد في المستقبل أكثر من موقع لها.
لنعمل على أن لا تكون سياستنا سياسة اللحظة، أن لا تكون خطّتنا خطّة اللحظة، المستقبل واسعٌ، ونحن مَنْ نقرأ الحكمة: »اعمل لدنياك كأنَّك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنَّك تموت غداً«، ونحن نعمل لآخرتنا كأنَّنا نعيش أبداً ونعمل لدنيانا كأنَّنا نموت غداً، نهزم غداً، ونسقط غداً، ونتراجع غداً.
نحو غد الأحرار:
إنَّ غد الأحرار واسعٌ طويل ممتد، غد الذين يؤمنون بالرسالات كبير في حجم العالـم، المهم أن نكون الكبار في رسالتنا بعدما أرادنا اللّه أن نكون كباراً في إيماننا به، لا نتحدّث عن شعار أو عن عاطفة، ولكنَّ اللّه قال لكم: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (البقرة:110) {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة}، فلماذا تتعبكم القوّة وترهقكم؟ وربَّما نجد بعضنا يخاف من أن يكتشف نفسه قوياً، لأنَّ قوته سوف تتعب حياته.
إنَّ حياتنا هي أمانة اللّه عندنا، وأرضنا هي أمانة اللّه عندنا، وإنساننا أمانة اللّه عندنا، واللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {إنّا عرضنا الأمانة على السَّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولاً} (الأحزاب:72)، وقد أرادنا اللّه أن لا نظلم أنفسنا، وأن لا نجهل مسؤوليتنا، فلننطلق في أجواء المعرفة لنتعرّف على كلّ الواقع في الحاضر والمستقبل، ولننطلق من خلال إيماننا بربّنا وبحقّنا وبأنفسنا، وعند ذلك يفرح المؤمنون بنصر اللّه، واللّه قال لنا في حديثه ـ ونحن نحبّ دائماً أن نربح الجنّة بالمزيد من التسابيح وبالمزيد من الأدعية والصلوات، ولا نريد الجنّة شهادةً ولا قتالاً في سبيل اللّه ولا جهداً في مواقع التحدّي ـ: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللّه ألا إنَّ نصر اللّه قريب} (البقرة:214) والقرب لا يُعَدُّ بالأيام، ولكنَّه يُقاس بمقدار ما تعطي من جهدك وعقلك وحركتك في الحياة {وأخرى تحبّونها نصرٌ من اللّه وفتحٌ قريب وبشّر المؤمنين} (الصفّ:13).
وهكذا.. لقد انطلق في مولده ليشق الطريق إلى الإسلام، وعلينا في ذكرى مولده أن نحتضن الإسلام في عقولنا وفي قلوبنا وفي أرواحنا، وأن نجعل من أيامنا أياماً إسلامية، وهذا ما نختم به الكلمة، كلماتٍ من دعاء الصباح للإمام زين العابدين (ع): »اللّهمّ ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحقّ وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف«.
{يا أيُّها الذين آمنوا اتَّقوا اللّه ولتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ واتَّقوا اللّه إنَّ اللّه خبير بما تعملون * ولا تكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون * لا يستوي أصحاب النّار وأصحاب الجنّـة أصحاب الجنّة هم الفائزون} (الحشر:18ـ20)، {إنَّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن} (التوبة:111).
هذا هو الطريق، ويبقى المهم أن نعرف كيف نحرّك أقدامنا في الطريق إلى اللّه.
ملامح العظمة في شخصية الرسول (ص)
بين عظمة وعظمة:
من العظماء، من إذا استغرقت في عناصر شخصيته فإنَّك تلتقي بذاته في نطاق الدائرة المحدودة من تلك العناصر التي جعلت منه إنساناً عظيماً صاحب فكرٍ أو صاحب قوّةٍ وما إلى ذلك، ما يمنح شخصيته ضخامتها الذاتية التي لا تمتد إلى أبعد من ذلك. ومن العظماء من إذا استغرقت في داخل شخصيته فإنَّك تنفتح على العالـم كلّه، ذلك هو الفرق بين عظيم يجمّع عناصر عظمته من أجل أن يؤكّد ذاته وبين عظيم يجمّع هذه العناصر من أجل أن يعطي الحياة عظمة ويتجه بالإنسان إلى مواقع العظمة حتى تكون عظمته حركة في الحياة، حركة في الإنسان، ويجتمع الإنسان والحياة وينطلقا ليعيشا مع أجواء العظمة في اللّه العليّ العظيم.
من أولئك أنبياء اللّه الذين عاشوا للّه، فاكتشفوا الحياة من خلاله لأنَّها هبته، واكتشفوا الإنسان من خلاله، لأنَّه خلقه. وبذلك، فإنَّهم لـم يعيشوا مع اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ استغراقاً في ذاته بالمعنى العاطفي للكلمة، لتكون كلّ حياتهم مجرّد تأوّهات وتنهّدات وحسرات وما إلى ذلك، ولكنَّهم رأوا بأنَّهم عندما ينقذون الإنسان من جهله، إنَّما بذلك يعبدون اللّه، فقد ارتفعوا إلى اللّه من خلال رفعهم للإنسان إلى مستوى المسؤولية عن الحياة من خلال تعاليم اللّه، عاشوا الآلام والحسرات مع اللّه من خلال حملهم لآلام الإنسان وتنهّداته من أجل أن تنطلق روحانيتهم في قلب مسؤوليتهم.
ولذلك فالأنبياء ليسوا شخصياتٍ عظيمةً تعيش في المجال الطبقي الذي يصنعه النّاس لعظمائهم، ولكنَّ الأنبياء كانوا يعيشون مع النّاس، كانوا فيهم كأحدهم، يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، يفتحون قلوبهم لإنسان يعيش ألماً من أجل أن يفسحوا المجال للفرح حتّى يطرد ذلك الألـم، يتواضعون للنّاس، يستمعون إلى آلامهم، يشاركونهم، يعيشون معهم، لا يتحسّسون في أنفسهم أيّة حالة علوّ وهم في المراتب العليا، وممّا تنقله لنا السيرة »بأنَّ رسول اللّه كان ذات يوم يسير ورأته امرأة فارتعدت هيبةً له فقال (ص): ما عليك إنَّما أنا ابن امرأة مثلك كانت تأكل القديد«.
إنَّه لـم ينفتح على ما عاشته من هيبته لتكون هيبته فاصلاً بينها وبين إحساسها الإنساني به وإحساسه الإنساني بها، لـم يرد للعظمة أن تكون حاجزاً بين إنسان وإنسان كما يفعل الكثيرون ممن يتخيّلون أنفسهم خطباء أو يرفعهم النّاس إلى صفوف العظماء فإذا بك تجد بينهم وبين النّاس حواجز وحواجز لا يعيشون التفاعل مع النّاس، وبذلك سقطت عظمتهم من خلال ما كانوا يؤكدونه من عظمتهم.
سرّ الإنسانية في النبوّة:
أمّا رسول اللّه (ص) فقد ارتفع إلى أعلى درجات العظمة عندما عاش حياة الإنسان، محتضناً له، ليرحمه وليرأف به، فلأنَّ سرّ إنسانيته في سرّ نبوته، في سرّ حركته في الحياة. لذلك قد نجد أنَّ بعض النّاس يتحدّثون في أشعارهم عن جمال الرسول (ص) وعن لون عينيه وعن جمال وجهه ويتغزّلون به من خلال ذلك، في الوقت الذي نرى أنَّ اللّه لـم يتحدّث عن كلّ ذلك، والسبب في ذلك أنَّ اللّه أراد أن يقول لنا بأنَّ الأنبياء الذين هم رسل اللّه إلى النّاس، انطلقوا مع الإنسان في صفاته الإنسانية التي تلتقي بالإنسان الآخر، أن تكون أيّ شيء في جمالك، أن تكون أيّ شيء في خصائص جسدك ذاك شيء يخصك لا علاقة له بالنّاس، لكن ما هي أخلاقك، ما هي انفعالاتك بالنّاس، ما هو احتضانك لحياة النّاس، ما هي طبيعة أحاسيسك، هل هي أحاسيس ذاتية تعيشها في ذاتك أو هي أحاسيس إنسانية تحتضن بها أحاسيس النّاس؟ كيف قدّمه اللّه إلينا؟
لـم يذكر لنا نسبه، ونحن دائماً نصرّ على العائلية في الحديث، فلـم يتحدّث لنا عن هاشميته ولا عن قرشيته ولا عن مكيته، لـم يحدّثنا عن اسم أبيه، عن اسم أمّه، ولكن حدّثنا عنه بصفته الرسولية الرسالية: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم}، لـم يأتِ من فوق ليطلّ عليكم من علياء العظمة، ولد بينكم، عاش معكم، تألَّـم كما تتألمون، وعاش الجوع كما تعيشون، وعاش اليُتم كما تعيشون اليُتم عندمـا تكونون أيتاماً، {من أنفسكم} وكلمة من أنفسكم تحمل في داخلها عمق المعنـى الإنسانـي الذي يجعل النبيّ (ص) في الصورة القرآنية إنساناً مندمجاً بالنّاس الآخرين، يعيش معهم، من داخل حياتهم، من داخل آلامهم، من داخل أحلامهم، من داخل قضاياهم، بحيث لا يوجد بينهم وبينه أيّ فاصل، إنَّه يتابعكم وأنتم تتألمون، يتابعكم وأنتم تتعبون، يتابعكم وأنتم تواجهون مشاكل الحياة التي تثقلكم، يعزّ عليه ذلك ويؤلمه ويثقله، لأنَّه يعيش دائماً في حالة نفسية متحفزة تراقب وترصد كلّ متاعبكم ومشاقكم {حريص عليكم} وكلمة حريص هنا تختزن في داخلها الكثير من الحنان، من الأبوة، من الاحتضان، من العاطفة.. يحرص عليكم فيضمّكم إليه، فتعيشون في قلبه، يقدّم لكم حلولاً لمشاكل حياتكم، عن كلّ تعقيداتكم، يحرص عليكم فيوحّدكم، ويجمع شملكم تماماً كما يحرص الأب على أبنائه والأم على أولادها، حريصٌ عليكم يخاف أن تضيعوا، يخاف أن تسقطوا، يخاف أن تـموتوا، وهو {بالمؤمنين رؤوف رحيم} (التوبة:128) الرأفة كلّها والرحمة كلّها، والرحمة في القرآن الكريـم ليست مجرّد حالة عاطفية، نبضة قلب وخفقة إحساس، بل الرحمة هي حركة الإنسان فيما يمكن له أن يحمي الإنسان، من نفسه، ومن غيره، من أجل الانطلاق بالإنسان.
رسول الرحمة:
ألـم نقرأ الآية الثانية وهي تحدّثنا عنه {فبما رحمةٍ من اللّه لنت لهم}، هذه الرحمة الإلهية التي أنزلها اللّه على النّاس من خلال تجسّدها في النبيّ، بحيث بعث إليهم رسولاً يعيش وعي الواقع ويواجه كلّ التحجّر، تحجّر التقاليد، والعادات والعقائد، والتعقيدات، وما إلى ذلك، فيواجه ذلك وهو يرى أنَّ هذا التحجّر يمكن أن يتحوّل إلى حجارة ترميه تماماً كما كانت الحجارة تدمي رجليه وهو في الطائف، وكما كانت حجارة القذارات تثقل جسده وهو عائد من البيت الحرام أو ساجد بين يديّ ربِّه. كان يعرف أنَّ هناك تحجّراً، وأنَّ الذي يريد أن يبعث الينابيع في قلوب النّاس لا بُدَّ له أن يكتشف في الحجارة شيئاً من الينبوع، لأنَّ اللّه حدّثنا أنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الماء، إنَّ هناك ينابيع في قلب الحجارة، لذلك لا تنظر إلى حجرية الحجارة ولكن انفذ إلى أعماقها.
لذلك لا تنفذ إلى النّاس المتحجّرين لتقول إنَّ هؤلاء لا ينفع معهم كلام ولا يمكن أن ينطلقوا إلى الحوار، اصبر جيّداً، انطلق بالينبوع من قلبك، ليكن قلبك ولسانك لينين، فإنَّ لين القلب ينفذ إلى أعماق الحجارة ليخرج منها الماء، ولين الكلمة تنفذ إلى حجارة العقل من أجل أن تفتح فيها أكثر من ثغرة {فبما رحمة من اللّه لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك} (آل عمران:159)، قال ذلك لكلّ إنسان يحمل مسؤولية فكر يريد أن يُقنع به إنساناً، أو يحمل مسؤولية عاطفة يريد أن يفتح عليها قلب إنسان، قال: أيُّها الإنسان المسؤول: المسؤولية تعني وعي إنسانية الآخر والصبر عليه، إن كنت مسؤولاً لا تصبر ابتعد عن المسؤولية، لأنَّك سوف تثقل النّاس فيما تعتبره مسؤوليتك، وإن لـم تعِ أمور النّاس، ولا تفهم حركية عقولهم وقلوبهم وأوضاعهم الحياتية فكيف يمكن أن تخاطب النّاس؟ فتِّش عن مفتاح الشخصية، وهو مفتاحٌ لا تصنعه عند صانع المفاتيح ولكن تصنعه وتأخذه من خلال خالق المفاتيح {وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاَّ هو} (الأنعام:59).
ومن مفاتيح الغيب تنطلق مفاتيح الرسالة، ومن مفاتيح الرسالة تنطلق مفاتيح الوعي وتنفتح الحياة كلّها، صفاته هي رسالته، ولذلك إذا أردت أن تتحدّث عن صاحب أيّ فكرة فلا بُدَّ أن تتحدّث عن أخلاقيته في حركة الفكرة، لأنَّ ذلك هو الرابط الأساسي له بالنّاس، أمّا في مجال العلاقة بالإنسان الذي يتحلَّى بالجمال ويتمتع بقوّة جسدية فذلك ينحصر في المجال الذاتي لشخصيته، أمّا عن علاقة الإنسان بالإنسان فهي علاقة حركة الفكر، الذي يحتاجه الإنسان من إنسان آخر.
الأسوة والقدوة:
وهذا ما يحدّثنا اللّه عنه في صفات رسوله (ص)، فإنَّه يقول لنا: {لقد كان لكم في رسول اللّه أسوةٌ حسنة} (الأحزاب:21)، فتقولون هذه صفات رسول اللّه فأين نحن من رسول اللّه؟ إنَّ اللّه يقول لكم: إنَّ رسول اللّه انطلق في سيرته من خلال رسالته ورسالته بين أيديكم، فإذا لـم تستطيعوا أن تقتربوا من مستوى العظمة في وعيه لرسالته، ولـم تستطيعوا أن تبلغوا القمة حاولوا أن تقتربوا من القمة ولو قليلاً، والقدوة في المسألة الإنسانية هي إيحاءٌ للإنسان إن بإمكانك أن تقترب من القمة إذا لـم تستطع أن تصل إليها. وهكذا لن يكون الرسول (ص) مجرّد رسول في التاريخ، ولكنَّه ـ وذلك سرُّ عظمته ـ كان رسالة في رسوليته، وكانت رسوليته هي الامتداد لشخصيته، حتّى أنَّنا نشعر أنَّ حضوره فينا ونحن نصلّي عليه ونستحضر سيرته وندرس سنته ونقرأ القرآن الذي بلَّغه، بأنَّ حضوره فينا كأفضل الحضور أعظم من حضور كثيرٍ من النّاس الذين يحسبون أنفسهم حاضرين ولكنَّهم غائبون عن الأمّة، قد يكونون حاضرين في الساحة بأجسادهم ولكنَّهم غائبون عن عقول الأمّة وقلوبها وإحساسها، وقضية الحضور والغياب هي في مدى وعي النّاس الذين تعيش في داخلهم لا من خلال الحجم الذي تتّخذه لنفسك في سلطانك.
لذلك مَنْ مِنَّا ـ وكلّ واحد منّا يحمل مسؤولية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مسؤوليته العائلية، التربوية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، أيّ شيء فيما يتعامل معه النّاس من مسؤوليات ـ مَنْ مِنَّا يعيش هذه الروح في الكلمة اللينة، القلب اللين، الروح التي يشق عليها تعب الذين يعيشون في داخل مسؤوليتك، الحرص الذي يشعر به على حياة النّاس الذين يتحرّكون من خلال مسؤوليتك؟!
لن نكون في خطّ رسول اللّه إذا لـم يتحوَّل كلّ واحد منَّا إلى رسول اللّه ولو بنسبة العشرة بالمائة، أو من خلال القدوة، وعلى الإنسان في حال اعترضته مشاكل نفسية وبيئية وما إلى ذلك أن يخترق كلّ الحواجز، والمهم في كلّ ذلك أن نمتلك الإرادة.
قصتنا في كثيرٍ من الحالات، هي هذا الفاصل بين الفكرة والإرادة، بين الرغبة والحركة، الرغبات تبقى أحلاماً، وبدلاً من أن نُنـزل هذه الأحلام إلى الواقع نحاول أن ننطلق بها إلى الخيال، والفكرة تبقى في عقولنا مجرّد معلومات، والقيمة الكامنة في المعلومات هي عندما تتحوّل إلى واقع، وإلاَّ كانت وهماً، كثيرٌ من الفلاسفة حشروا أنفسهم وتحوّلت فلسفاتهم إلى هواء، وأصبحت مجرّد شيء يُتعب عقلك ولا يغذي الحياة.. وجاء النّاس الذين يفكرون في الإنسان في رسالتهم، واستطاعوا أن ينطلقوا بالإنسان إلى مجالات واسعة.
إذاً قيمة الفكرة أن تتحوّل إلى واقع، ونحن نعرف، حتّى في قرآننا وفي سنتنا، أنَّه لا قيمة للإيمان إذا لـم يكن مقترناً بالعمل الصالح، لأنَّ العمل الصالح هو حركية الإيمان في واقعك، كما أنَّ الإيمان هو حركية الصلاح في عقلك، وعندما تكون صالحاً في عقلك من خلال إيمانك وتكون صالحاً في عملك من خلال حركة إيمانك، عند ذلك يمكن أن تعطي الحياة صلاحاً، هذا هو {وإنَّك لعلى خلق عظيم} (القلم:4)، هل الخلق ابتسامة؟ هل الخلق مجرّد مصافحة حنونة؟ هل هو مجرّد مجاملات؟ هل الخلق حالة عناق أو احتضان؟ الخلق هو أنت في كلّ حركتك في الحياة، الأخلاق تختصر كلّ حياتك، علاقتك بنفسك هي خُلُق، علاقتك باللّه، علاقتك بعيالك، علاقتك بالنّاس الذين تعمل معهم ويعملون معك، علاقتك بالحكم، بالحاكم، بالقضايا الكبرى. وبعبارة أخرى، الأخلاق ليست شيئاً على هامش حياتنا، إنَّما هي كلّ حياتنا، هي أسلوبنا في الحياة، أسلوبنا في التعامل، أسلوبنا في الكلام، أسلوبنا في اتخاذ المواقف، أسلوبنا في تحديد المواقع، أسلوبنا في مواجهة التحدّيات، ولذلك رأينا أنَّ رسول اللّه (ص) اختصر الإسلام كلّه بكلمة واحدة: «إنَّما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق».
الرسالات كلُّها هي حركةٌ في واقع الإنسان من أجل أن تتمِّم له أخلاقه، ولكلّ مرحلة أخلاقها، وتأتي المرحلة الثانية لتكمل ما نقص ممّا جدّ واستجدَّ من قضايا الحياة ومشاكلها، حتى كان ختام الأخلاق الرسالية هو ختام الرسالة في محمَّد (ص) الذي جاء ليتمِّم ويكمل للإنسان أخلاقه، وانطلق بالإسلام لا ليكون ديناً في مقابل الأديان، ولكنَّه دين يحتضن كلّ الأديان، مصدّقاً لما بين يديه، يؤمن بالرسل كلّهم، ينطلق ليأخذ من كلّ رسالة ما أراد اللّه له أن يأخذه ممّا يبقى للحياة، لأنَّ هناك شيئاً في الرسالات قد يكون مرحلياً، ولذلك جاء عيسى (ع) ليحلّ لهم بعض ما حرّم عليهم، وجاء موسى قبله ليحرّم عليهم بعض ما أحلّ لهم. والقضية هي أنَّ قيمة الإسلام هي هذه، الإسلام ليس ديناً في مواجهة اليهودية، كما يواجه الفكر الخصم فكراً خصماً آخر، وليس في مواجهة النصرانية، ولكنَّه يحتضن ما يبقى من النصرانية وما يبقى من اليهودية وما يبقى من صحف إبراهيم وما يبقى من كلّ النبوَّات صغيراً أو كبيراً، ليقول للإنسان كلّه: أيُّها الإنسان، لقد كان هناك تاريخ للرسالات وأنا اختصرت لك كلّ هذا التاريخ، آمن بالرسل كلّهم، ولتكن حياتك في خطّ الرسل كلّهم، فأنا خاتمهم وأنا معهم أسير.
خصوصية الإسلام:
ولذلك فإنَّ مقدسات اليهودية في رموزها هي مقدّساتنا، وكذلك فيما يتعلّق برموز النصرانية ومقدّساتها، قد ينطلق يهودي أو نصراني ليسبّ مقدّساتنا، ولكنَّنا لا نستطيع أن نقف بردة فعل لنسبّ مقدّسات هذا أو ذاك، لأنَّ مقدّساتهم مقدّساتنا، لأنَّ موسى كما عيسى هما من أنبيائنا، ولأنَّ مريـم العذراء (ع) هي الإنسانة التي كرّمها اللّه وطهَّرها وفضَّلها على نساء العالمين، لذلك ماذا نقول؟ إنَّنا ندعو لهم بالهداية، هذا ردّ فعلنا، وهكذا نتعلّم من هذه الشمولية في حركة الإسلام الذي يمثّل إسلام القلب والعقل والفكر والوجه للّه ـ سبحانه وتعالى ـ ننطلق لنكون المنفتحين على الحياة كلّها وذلك من خلال الرسول إلى الرسالة.
فنحن نقرأ القرآن، والقرآن يحدّثنا عن كلّ ما أثير حول الرسول (ص) من خلال ما قال عنه المشركون بأنَّه ساحر، شاعر، كاهن، كذاب، كما قالوا عن القرآن بأنَّه {أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً} (الفرقان:5)، وقالوا عنه {إنَّما يعلّمه بشر}.
لقد حدّثنا القرآن عن كلّ ذلك، وبلّغ الرسول (ص) هذه الاتهامات للنّاس، قائلاً للذين لـم يعيشوا تجربة مكة، ومن خلال آيات اللّه: هذا نبيّكم قيل عنه إنَّه مجنون وقيل عنه إنَّه كاذب وساحر وكاهن وقيل عن قرآنكم إنَّ هناك بشراً علم النبي!! لـم يخف من أن يضل النّاس بالحديث عن نقاط الضعف التي أثاروها زوراً وبهتاناً.
ونستوحي من خلال ذلك بأنَّ الإنسان الذي يملك الحقّ لا يخاف من كلّ الكلمات التي تصوّر حقّه باطلاً. إذا كنت إنساناً تملك قوّة الحقّ في حياتك فليقل النّاس ما يقولون، عليك أن لا تخاف، لأنَّ الحقّ أقوى من كلّ ما يقولون إذا كانوا يقولون الباطل، واللّه تكفّل أن يزهق الباطل، أن يزهقه من عقول النّاس إذا لـم يُزهق من حياتهم.
كما أنَّنا نتعلّم من ذلك أن لا نتعقّد عندما نكون مسؤولين، أن لا نتعقّد من الاتهامات التي توجّه إلينا.. كن مسؤولاً في موقع ديني، كن مسؤولاً في موقع اجتماعي، كن مسؤولاً في موقع رسالي، إنَّ معنى مسؤوليتك هي أنَّك تقف موقف التحدّي لفكر الآخرين ولمصالح الآخرين أو لأوضاع الآخرين، ولذلك من الطبيعي أن يحاربك الآخرون منذ البداية بما يكذبون ويفترون، عليك أن تعتبر أنَّ ذلك أمر طبيعي في ساحة الصراع.
.. في مواجهة الشتائم:
ومن يخاف أن يشتمه النّاس أو أن يتهموه أو أن يرجموه عليه أن ينسحب من المسؤولية، لأنَّ المسؤولية تحتاج إلى إنسانٍ يملك صلابة العقل الذي لا تهزه التحدّيات الفكرية، وصلابة القلب الذي لا تُسقطه التحدّيات الانفعالية، وصلابة الموقف الذي لا تهزّه التحدّيات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. عندما تريد أن تكون مسؤولاً حاول أن تصلّب عضلاتك، لا عضلات يديك، بل عضلات عقلك، لأنَّ للعقل عضلات، حاول أن تصلّب عضلات قلبك، عضلات حركتك، عند ذلك تكون كما قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) لولده محمَّد وهو يقف في المعركة: »تدْ في الأرض قدمك، أعرِ اللّه جمجمتك، ارم ببصرك أقصى القوم، تزول الجبال ولا تزول«.
وكانت هناك جبال من الشتائم والاتهامات لرسول اللّه وزالت كلّ تلك الجبال، وبقي رسول اللّه وبقيت رسالته، قالوا عنه إنَّه مجنون، تعلّموا أساليبه عندما تواجهكم الأساليب الظالمة غير الواعية، {قل إنَّما أعظكم بواحدة}، استدركوا لحظةً في أنفسكم عندما يتهمكم أحد بالجنون، كيف وأنت شخصٌ محترم في عائلتك، في موقعك الاقتصادي، في موقعك السياسي، ويأتي من يتّهم عقلك، أو أن يكذبوه، ونسوق مثالاً على ذلك ما كان يتعرّض له رسول اللّه (ص) من أقربائه، كأبي لهب الذي كان يتتبّعه ويقول: «لا تصدّقوا ابن أخي، فإنَّه مجنون ومن أعرف بالإنسان من عمّه«، كيف تكون أعصابك، كيف تكون ردود فعلك؟ ألا تنطلق لتستبدل شتيمة وكلمة جارحة بكلمة جارحة؟! وكلّنا نعتبر أنَّ لنا العذر {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} (البقرة:194)، ولكنَّ رسول اللّه لـم يكن شخصاً يستغرق في ذاته، بعد أن قال اللّه له لا تنفعل ولا تحزن، القضية ليست قضيتك، {فإنَّهم لا يكذبونك ولكنَّ الظالمين بآيات اللّه يجحدون} (الأنعام:33)، ولذلك يقول له: {واصبر على ما أصابك إنَّ ذلك من عزم الأمور} (لقمان:17) فالقضية هي قضية رسالة لا بُدَّ أن تحطِّم الحواجز، وتحطيم الحواجز الإنسانية أخطر من تحطيم الحواجز الحديدية وما إلى ذلك.
{قل إنَّما أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه مثنى وفرادى ثُمَّ تتفكروا ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلاَّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد} (سبأ:46)، إنَّه أراد أن يعلّمهم المنهج في وعي القضايا التي يخطئون فيها، لقد انطلق هذا الأسلوب القرآني ليتعامل معهم كما يتعامل مع إنسان مخطئ يريد له أن يكتشف خطأه، لا أن يقنعه بخطئه، أن يقول له إنّي أدلك على المنهج الذي إذا أخذت به، فإنَّك تستطيع أن تكتشف خطأك بنفسك، ما هو المنهج؟ إنَّ المشكلة ـ هكذا أراد اللّه لرسوله أن يقول لهم ـ هي أنَّكم مجتمعون لا يملك أحدٌ منكم عقله بشكل مستقل، لأنَّ الإنسان عندما يكون مع النّاس فإنَّ عقله يكون عقل النّاس.. راقبوا ذلك في أوضاعكم، قد تجلسون في محفل والنّاس يصفقون، فإنَّكم ترون أنفسكم مشدودين إلى أن تصفقوا دون أن تعرفوا لماذا يصفقون، وهكذا عندما تنطلق مظاهرات يهتف إنسان بسقوط إنسان وبحياة إنسان، إنَّك ترى نفسك تهتف دون أن تعرف لماذا وما هي المناسبة. هذا ما عبّر عنه بعض علماء النفس »بالعقل الجمعي«. وبعبارة أخرى، يفقد الإنسان في هذه الحالة عقله الذاتي، وبالتالي صفاء التفكير وصفاء المنطق.
لذلك، فإنَّ النبيّ (ص) كأنَّه كان يقول لهم من خلال هذه الآية: أنا لا أقول لكم إنّي مجنون أو لست مجنوناً، لا أدافع عن نفسي بشكل مباشر، لكن أنصحكم وأطلب منكم شيئاً واحداً أن تقوموا للّه، واجهوا القضية من موقع إرادة وعي الحقيقة لا من موقع العصبية؛ مثنى، اثنين اثنين تتحدّثان فيما بينكما؛ فرادى، واحداً واحداً يفكّر، فكِّروا مثنى وفرادى، فكِّروا في كلماتي، فكِّروا في طريقتي في الحياة، فكِّروا في كلّ أوضاعي، فإنَّكم إذا فكَّرتـم بهدوء فستعرفون أنَّ صاحبكم ليس مجنوناً، ولكنَّه يحدّثكم عن شيءٍ على جانب كبير من الأهمية يخصُّ مصيركم {إن هو إلاَّ نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديد} (سبأ:46).
وهذا المنهج هو المنهج الذي يضعه الإسلام أمام الإنسان ليقول له: عندما تريد أن تركّز فكرةً لتعيش صفاءها ونقاءها وعمقها اجلس مع نفسك وفكِّر، اجلس مع إنسان آخر وفكِّر معه، وإيّاك أن تتبنى أفكاراً أو تضع أفكارك وأنت بين النّاس، لأنَّ النّاس سيفرضون عليك بهذا التيار الضاغط فكراً لـم تختره، وفكراً لو حرّكته بهدوء لما اقتنعت به، تماماً كما هو التيار عندما تقف في مواجهته، فإنَّك لا بُدَّ أن تسير معه، أمّا عندما يكون البحر هادئاً فإنَّك تستطيع أن تسبح بإرادتك وتعرف كيف تحرّك يديك بطريقتك الخاصة.
وهكذا كان أسلوبه يتنوّع من خلال أنَّه يريد للنّاس أن يقتنعوا على أساس وعيهم للقضية، ولذلك كان لا يستعجل اللّه العذاب، بل كان يقول: »اللهم اغفر لقومي فإنَّهم لا يعلمون«. هل نطيق مثل ذلك؟ هل يطيق المسؤولون مثل ذلك؟ أياً كان المسؤولون؟! إنَّ المسلمين لا بُدَّ أن يكونوا كذلك، لأنَّ هذه ليست صفة من خصائص الرسالة في شخصية الرسول، ولكنَّها صفةٌ من خصائص الرسول في معنى الرسالة، ويمكن للنّاس أن يأخذوا بها. كان الرسول يخاطب الآخرين ولو لـم يكونوا قادرين على ذلك لما خاطبهم بذلك.
لنتعلّم من سيرته (ص):
إنَّنا عندما ننفتح على الرسول فعلينا أن ننفتح على كلّ سيرته، لأنَّ سيرته كانت رسالةً كما جاء في تعريف سنّة النبيّ (ص): »السنّة قول النبيّ أو فعله أو تقريره«، قوله سنّة، وحركته في الحياة سنّة، ورضاه بما يرى ممّا يقرّ النّاس عليه سنّة، لذلك هو شريعة بكامله، وقد عبّرت إحدى زوجاته بإيجاز عن خلقه فقالت: »كان خلقه القرآن«. فإذا أردتـم أن تدرسوا سيرته (ص)، فليس من الضروري أن تقرأوا سيرته في كتب السيرة، بل اقرأوا القرآن بكلّ أخلاقياته، وبكلّ حرامه وحلاله، وبكلّ حركته في الحرب والسلم، فستجدون أمامكم الصورة الواضحة لمحمَّد (ص)، لأنَّه عاش القرآن في كلّ كيانه قبل أن يبلّغه للنّاس، فكان القرآن الناطق، وكان ما يسمعونه القرآن الصامت.
في حركته يتجسّد القرآن، وهذا هو الالتزام الإسلامي، وعليه يجب أن نركّز، لأنَّ ذكرى المولد أو أيّ ذكرى في مناسباته ليست احتفالاً نعيش فيه فرح أدبياته، ولكن أن نعيش فرح حياتنا ومصيرنا، ذلك هو الفرح الحقيقي.. لا بُدَّ أن نكون قرآنيين إذا أردنا أن ننطلق في النور، وعندما تكون قرآنياً عليك من خلال التزامك بالقرآن أن يكون انتماؤك للقرآن لا لشيء غير ذلك، فكما لا يمكن أن يكون للّه شريكٌ في عقيدتك كذلك لا يمكن أن يكون للإسلام شريكٌ في انتمائك، أن تكون مسلماً يملأ الإسلام كلّ فراغ عقلك وكلّ فراغ قلبك وكلّ فراغ أحاسيسك وكلّ فراغ شهواتك وغرائزك وحركتك وعلاقاتك ومواقفك من خلال ذلك {اليوم أكملت لكم دينكم} فلا تبحثوا عن شيء آخر، لأنَّ الذي يبحث عن شيء آخر إنَّما يبحث عمّا نقص لديه من دنياه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً} (المائدة:3)، فإذا كان اللّه رضي لنا الإسلام ديناً أفلا نرضى بما رضيه اللّه لنا؟!
والإسلام ليس هامشاً من هوامش الحياة أو من هوامش التشريع، هو كلّ الحياة لو فهمناه، هو كلّ الواقع لو وعيناه، هو كلّ الشريعة لو أخذنا بدقائقه وبكلّ مفرداته وقواعده.
لذلك لا تعيشوا الازدواجية، كلّنا نعرف الحقيقة الإنسانية، الإنسان لا يعيش حياته مرتين، إنَّ بعض النّاس عاشوا حياتهم بعيداً عن اللّه لأنَّهم كانوا في غفلة عنه، وعندما حان وقت لقاء اللّه ورأوا الحقيقة {قال ربّي ارجعون * لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت} (المؤمنون:99ـ100)، أعطني يا ربّي حياةً ثانية أعيش فيها الحقّ بعدما سرت في حياتي الأولى وعشتها!، ليست هناك حياة ثانية، كما أنَّ الحياة الواحدة لا تنقسم.
كيف تقسّم عقلك لتكون مؤمناً في جانب وملحداً في جانب آخر؟ كيف تقسّم قلبك لتحبّ اللّه في جانب من قلبك ولتحبّ الشيطان في جانب من قلبك؟ اللّه لا شريك له في العقيدة ولا شريك له في الحبّ، حتى عندما تحبّ النّاس الآخرين لا بُدَّ أن تحبّهم من طريق اللّه، »إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر قلبك، فإن كان قلبك يوالي أولياء اللّه ويعادي أعداء اللّه ففيك خير واللّه يحبّك، وإن كان قلبك يوالي أعداء اللّه ويعادي أولياء اللّه فليس فيك خير واللّه يبغضك، والمرء مع من أحبّ« فاعرف من تحبّ لتعرف أين تسير، لأنَّ اللّه يحشرك مع من تحبّ.
ولذلك عندما ينحرف قلبك وتنحرف عواطفك حاول أن تمسك قلبك لتفكر: لو قال اللّه يا فلان إنّي أحشرك مع من أيّدته اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو عاطفياً فهل تقبل؟ إذا كنت تقبل ذلك من موقع الإيمان فأيِّده، وإذا لـم تقبل ذلك فوفّر على نفسك أن تحشر مع الذين يساقون إلى النّار، القضية بسيطة جداً ليس فيها فلسفة وليس فيها تعقيدات، القضية واضحة، الطريق المستقيم هو أقرب بُعدٍ بين نقطتين {وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله} (الأنعام:53).
إذاً أن نكون مسلمين، هو أن لا نتعصّب ضدّ غير المسلمين، وأن نقول لهم: {تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلاَّ اللّه ولا نشرك به شيئاً ولا يتّخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللّه} (آل عمران:64)، لن نتعقّد حتّى من الذين لا يؤمنون بدين ونقول لهم: {هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} (البقرة:111)، {ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فَلِمَ تحاجُّون فيما ليس لكم به علم} (آل عمران:66)، لن نتعقّد من أحد، ولكنَّنا نحبُّ النّاس كلّهم، نحبّ الذين نتفق معهم من أجل أن نلتقي بهم ونتعاون معهم، ونحبّ الذين نختلف معهم لنهديهم إلى سواء السبيل. الحاقد لا يستطيع أن يهدي أحداً، الأنبياء كانوا يبكون على النّاس. اللّه كان يخاطب النبيّ بين وقت وآخر {فلا تذهب نفسك عليهم حسرات} (فاطر:8)، كان النبيّ عندما يواجه الكافرين يتحسر عليهم الحسرة تلو الحسرة، لأنَّه كان يحبّ النّاس كلّهم ومن خلال حبّه لهم كان يهديهم إلى سواء السبيل.
لذلك نحن لسنا المسلمين الذين نعيش العقلية التدميرية ضدَّ أيّ إنسان، ولن نعيش العاطفة السلبية ضدّ النّاس، لقد علّمنا اللّه أن نجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، أن نجادل كلّ النّاس بالتي هي أحسن، وأن ندعو إلى سبيل ربّنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نقول التي هي أحسن، وأن نوازن بين الحسنة وبين السيئة، وندفع بالتي هي أحسن، حتّى نحوِّل أعداءنا إلى أصدقاء.
إذاً نحن لا نسيء إلى سلام العالـم من خلال اختلاف فكرنا عن بعض إنسان هذا العالـم، ولكنَّنا نؤكّد سلام الإنسان من خلال سلام الفكرة التي ترتكز على أسس علمية. أن تكون مسلماً ليس معنى ذلك أن تكون عاطفياً في المسألة، أن تكون مسلماً أن تأخذ بأسباب العلم، اللّه أراد للمسلمين أن يزدادوا علماً حتى أطلقه دعاءً يختصر كلّ العلم {وقل ربّي زدني علماً} (طه:114)، وأكّد سبحانه في القرآن على العلم وهو يميّز بين النّاس {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}، وعلى الذين يملكون العقل {إنَّما يتذكر أولو الألباب} (الزمر:9)، كما أكَّد على الإنسان في أيّ موقع من مواقع حياته أن لا يتَّبع ما ليس له به علم، في كلّ شيءٍ يأخذ به، في كلّ شيءٍ يلتزمه، في كلّ شيءٍ ينتمي إليه، في كلّ شيءٍ يتحرّك معه، {ولا تقفُ ما ليس لك به علم إنَّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولاً} (الإسراء:36). لا بُدَّ أن يكون لك وضوح الرؤية، ووضوح الكلمة المسموعة، ووضوح الفكرة المعقولة، سيسألك اللّه عن البصر وما رأى، وعن الأذن وما سمعت، وعن العقل وما وعى.
أمّ الحضارات:
لذلك أن تكون مسلماً يعني أن تتحرّك في حياتك من موقع علم ينظّم لك الحياة، ومن موقع عقل يؤكّد لك الفكرة. وبذلك فإنَّ المجتمع الجاهل ليس هو المجتمع الذي يحبّه الإسلام لأتباعه، والمجتمع المتخلّف ليس هو المجتمع الذي انطلق الرسول (ص) لصنعه، ومن هنا علينا أن نعرف أنَّ هذا التخلّف والجهل في الواقع الإسلامي هو شيءٌ غير إسلامي. إنَّ الإسلام استطاع أن يصنع الحضارة التي غذّت ما بعدها من الحضارات، ففي مدى أقلّ من مائة سنة، أصبحت الحضارة الإسلامية في عقلانيتها وفي علومها وفي أفكارها ومفاهيمها وأساليبها الفكرية تغذِّي الحضارات الأخرى. ونحن نقرأ في كتابات بعض المفكرين الغربيين: »إنَّ الحضارة الإسلامية هي أمّ الحضارات الحديثة«، لأنَّ أسلوب التجربة وأسلوب الاستقراء أخذه الغربيون من علماء المسلمين عندما كانوا في الأندلس. لذلك لا بُدَّ لنا عندما نريد أن ننطلق في الأجواء الإسلامية أن ننطلق في أجواء علمية، نأخذ الأسباب العلمية من أيّ مكان، حتّى نستطيع أن نحرّك الإنسان من خلال علمٍ ينتفع به في الحياة، ومن خلال رسالة تنظِّم له أخلاقية الحياة وسلوكية الحياة وتعرّفه طرق استخدام هذا العلم في سبيل بناء الإنسان لا في سبيل تدميره.
واللّه أراد لنا أن نكون الأعزّاء، لأنَّ اللّه أرادنا أن نتخلّق بأخلاقه، فالحديث الشريف يقول: »تخلّقوا بأخلاق اللّه« واللّه العزيز يريدنا أن نكون الأعزاء {وللّه العزّة ولرسوله وللمؤمنين} (المنافقون:8)، ولكن بشرط أن لا نبتغي العزّة عند الذين لا يؤمنـون باللّه {بشّر المنافقين بأنَّ لهم عذاباً أليماً * الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزّة فإنَّ العزّة للّه جميعاً} (النساء:139).
هذا عنوانٌ يحدّد لنا كلّ علاقاتنا بالنّاس وكلّ حركتنا في كلّ مواقع الصراع، إذا أردت أن تبرمج علاقاتك مع أيِّ قريب آخر أو أن تخطِّط لحياتك ولأوضاعك في أيّ طريق، فكِّر هل هو طريق عزّة أو طريق ذلّة، هل هو طريق حرية أو عبودية، لا تكن العبد حتّى لو استعبدت جسمك للنّاس، كن الحر الرافض حتّى لو كان العالـم كلّه يرفع يده للقوي، إذا لـم تقتنع بما يقوله النّاس. المسؤولية فردية في الإسلام {يوم تأتي كلّ نفسٍ تجادل عن نفسها} (النحل:111)، {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (الأنعام:164)، {وأن ليس للإنسان إلاَّ ما سعى * وإنَّ سعيه سوف يرى} (النجم:39ـ40)، المسؤولية فردية {يا أيُّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم} (المائدة:105)، تحمَّل مسؤولية نفسك إذا لـم تستطع أن تتحمَّل مسؤوليات النّاس من حولك.
لذلك عندما تفكِّرون في القضايا المصيرية فيما يتصل بأرضكم أو فيما يتصل بحريتكم أو ما يتصل بمواقعكم في ساحات الكون بين الأمم، ابحثوا عن موقع يضمن لكم حريتكم، ابحثوا عن ساحةٍ تؤكّد عزتكم، ابحثوا عن عالـمٍ يحمي أصالتكم، القضية ليست قضية موازين القوى، قد يكون لموازين القوى دورٌ فيما هي حركة جسدك، ولكن ليس لموازين القوى دورٌ في حركة قرارك وعقلك وإرادتك، «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده فمن لـم يستطع فبلسانه فمن لـم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». المهم أن لا نُغلب على عقولنا، أن نرى الحقّ باطلاً أو الباطل حقّاً، أو نرى الذلّ عزّاً أو العزّ ذلاً، كما قال ذلك الشاعر عندما يتحدّث عن أسلوب بعض النّاس: »تأنّق الذلّ حتى صار غفراناً« يحاول أن يغيّر كلمة الاستسلام بالسّلام، والذلّ بالغفران وما إلى ذلك من الكلمات.
أمامنا تحدٍٍّ كبير:
لذلك نحن كمسلمين وكعرب ـ باعتبار أنَّ أكثرية العرب هم مسلمون، وحتّى غير المسلمين من العرب إذا لـم يكونوا مسلمين دينياً فهم مسلمون حضارياً، لأنَّهم اختزنوا مفاهيم الإسلام في كلّ نموّهم الحضاري والاجتماعي ـ أمام تحدٍٍّ كبير بدأ يواجهنا منذ انطلقت الرسالة في المدينة وما زال يواجهنا حتّى الآن، والقضية أنَّ هناك واقعاً يُراد من خلاله أن يُقال للمسلمين إنَّ بني النضير وقريظة وخيبر أصبحت من التاريخ، لقد أخذنا منكم أكثر من خيبر وثأرنا لأكثر من بني قريظة أو بني النضير، إذا كانوا لا يقولون ذلك بألسنتهم فإنَّهم يقولونه من خلال مواقفهم، في الحفلة الجنائزية التي حملت فيها جنازة فلسطين في البيت الأبيض، حيث كان رئيس وزراء العدو يقف ليتحدّث عن آلام اليهود في التاريخ منذ ألفي سنة، وعن يهود المنفى ومآسيهم. هذا في الوقت الذي نجد فيه أنَّ الشخص الذي جاء يزحف إليه ويمدّ يده مدّة ليصافحه، لـم يتحدّث عن عرب ولا عن مسلمين ولا عن شهداء ولا عن مستقبل لكلّ هؤلاء المشرّدين عن أرضهم، إنَّ القضية هي: قالوا إنَّ فلسطين هي جوهر الصراع، وقد سقط الصراع بالتوقيع على ورقة الطابو، وكانوا يريدون في ورقة الطابو أن تكون فلسطين إسرائيلية. وفلسطين الآن حتى بعد اتفاق »غزة ـ أريحا« إسرائيلية، فهذا وزير خارجية العدو يقول: »إنَّنا لـم نتنازل عن الأرض وإنَّما تنازلنا عن تجمّع..« إنَّ هذا تحدٍّ كبير قد تتابعونه بطريقة استهلاكية فيما تقرأونه وتسمعونه، فتجدون مقولة النظام العالمي الجديد، واختلال موازين القوى لصالح الاستكبار، ولكن علينا أن نستمع بهدوء عقلاني قول اللّه: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * إن يمسسكم قرحٌ فقد مسّ القوم قرحٌ مثله وتلك الأيام نداولها بين النّاس} (آل عمران:139ـ140).
لماذا تصرّون على أن توقفوا الدولاب في الأسفل وهناك إمكانية أن يتحرّك الدولاب من الأسفل إلى الأعلى، لماذا تحبّون دائماً الموقع الأدنى، قال لكم اللّه: {أنتم الأعلون} ولكن {إن كنتم مؤمنين}، {الذين قال لهم النّاس إنَّ النّاس قد جمعوا لكم}، نفس الكلمة والنظام العالمي الجديد {فاخشوهم} قدّموا كلّ طاعتكم للاستكبار العالمي، عندما قالوا لهم إنَّ النّاس قد جمعوا لكم فانطلقوا إلى اللّه وأدركوا أنَّ القوّة للّه جميعاً «قل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء»، {فزادهم إيماناً} ولذلك ازدادوا بالتحدّي المضادّ إيماناً {وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل} {إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنَّ اللّه معنا فأنزل اللّه سكينته عليه وأيّده بجنودٍ لـم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اللّه هي العليا} (التوبة:40)، {... وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل * فانقلبوا بنعمةٍ من اللّه وفضلٍ لـم يمسسهم سوء واتّبعوا رضوان اللّه واللّه ذو فضل عظيم} (آل عمران:173ـ174) ().
أيُّها المخوّفون المنخذلون، أتعرفون أين هو مستوى تخويفكم {إنَّما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين} (آل عمران:175) خفِ اللّه وقِفْ أمام العالـم وكن مع اللّه، قد تقولون هذا كلام حماس استهلكناه، وهذا كلام انفعال استنفدناه. إنَّ التتر اجتاحوا البلاد الإسلامية في أكثرها ولـم يبقَ للمسلمين قوّة، ولكنَّ العقل الإسلامي اخترق عقل التتر فحوّلهم إلى مسلمين، وبذلك تحوّلت قوّة التتر إلى قوّة إسلامية بعد أن كانت قوّة دمّرت الإسلام... لماذا لا نثق بعقولنا، لماذا لا نثق بإسلامنا؟ لنتحرّك عقلانياً وعلمياً ومادياً وروحياً وننطلق.. وإذا ضاق الحاضر في مواقع قوّته، فالمستقبل قد يفتح لك أكثر من أفق. أتريدون الشواهد من عصرنا، كيف كانت بريطانيا في الخمسينات والأربعينات؟ كانت سيِّدة البحار، كيف كانت أمريكا عندما كانت مستعمرة بريطانية؟ أين أمريكا وأين بريطانيا الآن؟ كيف كان اليهود قبل الأربعينات وكيف هم الآن؟ {وتلك الأيام نداولها بين النّاس} (آل عمران:140)، إذا لـم تمتلك القوّة الآن حاول أن تؤمن بقدرتك على صنع القوّة، فقد تجد في المستقبل أكثر من موقع لها.
لنعمل على أن لا تكون سياستنا سياسة اللحظة، أن لا تكون خطّتنا خطّة اللحظة، المستقبل واسعٌ، ونحن مَنْ نقرأ الحكمة: »اعمل لدنياك كأنَّك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنَّك تموت غداً«، ونحن نعمل لآخرتنا كأنَّنا نعيش أبداً ونعمل لدنيانا كأنَّنا نموت غداً، نهزم غداً، ونسقط غداً، ونتراجع غداً.
نحو غد الأحرار:
إنَّ غد الأحرار واسعٌ طويل ممتد، غد الذين يؤمنون بالرسالات كبير في حجم العالـم، المهم أن نكون الكبار في رسالتنا بعدما أرادنا اللّه أن نكون كباراً في إيماننا به، لا نتحدّث عن شعار أو عن عاطفة، ولكنَّ اللّه قال لكم: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (البقرة:110) {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة}، فلماذا تتعبكم القوّة وترهقكم؟ وربَّما نجد بعضنا يخاف من أن يكتشف نفسه قوياً، لأنَّ قوته سوف تتعب حياته.
إنَّ حياتنا هي أمانة اللّه عندنا، وأرضنا هي أمانة اللّه عندنا، وإنساننا أمانة اللّه عندنا، واللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {إنّا عرضنا الأمانة على السَّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولاً} (الأحزاب:72)، وقد أرادنا اللّه أن لا نظلم أنفسنا، وأن لا نجهل مسؤوليتنا، فلننطلق في أجواء المعرفة لنتعرّف على كلّ الواقع في الحاضر والمستقبل، ولننطلق من خلال إيماننا بربّنا وبحقّنا وبأنفسنا، وعند ذلك يفرح المؤمنون بنصر اللّه، واللّه قال لنا في حديثه ـ ونحن نحبّ دائماً أن نربح الجنّة بالمزيد من التسابيح وبالمزيد من الأدعية والصلوات، ولا نريد الجنّة شهادةً ولا قتالاً في سبيل اللّه ولا جهداً في مواقع التحدّي ـ: {أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللّه ألا إنَّ نصر اللّه قريب} (البقرة:214) والقرب لا يُعَدُّ بالأيام، ولكنَّه يُقاس بمقدار ما تعطي من جهدك وعقلك وحركتك في الحياة {وأخرى تحبّونها نصرٌ من اللّه وفتحٌ قريب وبشّر المؤمنين} (الصفّ:13).
وهكذا.. لقد انطلق في مولده ليشق الطريق إلى الإسلام، وعلينا في ذكرى مولده أن نحتضن الإسلام في عقولنا وفي قلوبنا وفي أرواحنا، وأن نجعل من أيامنا أياماً إسلامية، وهذا ما نختم به الكلمة، كلماتٍ من دعاء الصباح للإمام زين العابدين (ع): »اللّهمّ ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحقّ وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف«.
{يا أيُّها الذين آمنوا اتَّقوا اللّه ولتنظر نفسٌ ما قدّمت لغدٍ واتَّقوا اللّه إنَّ اللّه خبير بما تعملون * ولا تكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون * لا يستوي أصحاب النّار وأصحاب الجنّـة أصحاب الجنّة هم الفائزون} (الحشر:18ـ20)، {إنَّ اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنّة يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن} (التوبة:111).
هذا هو الطريق، ويبقى المهم أن نعرف كيف نحرّك أقدامنا في الطريق إلى اللّه.
 »منتدي الدويم الحر «
»منتدي الدويم الحر «

 المشاركات:
المشاركات: